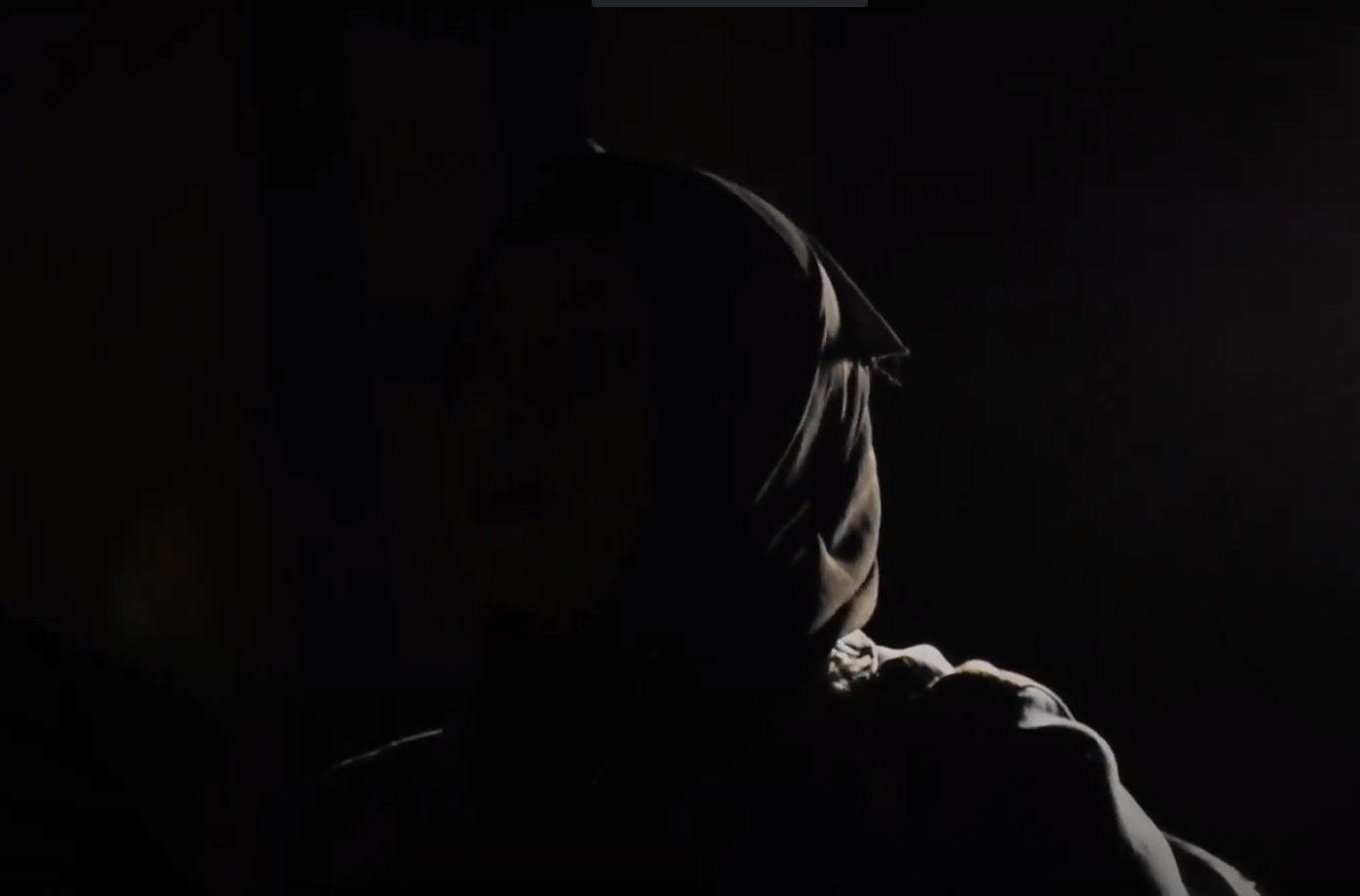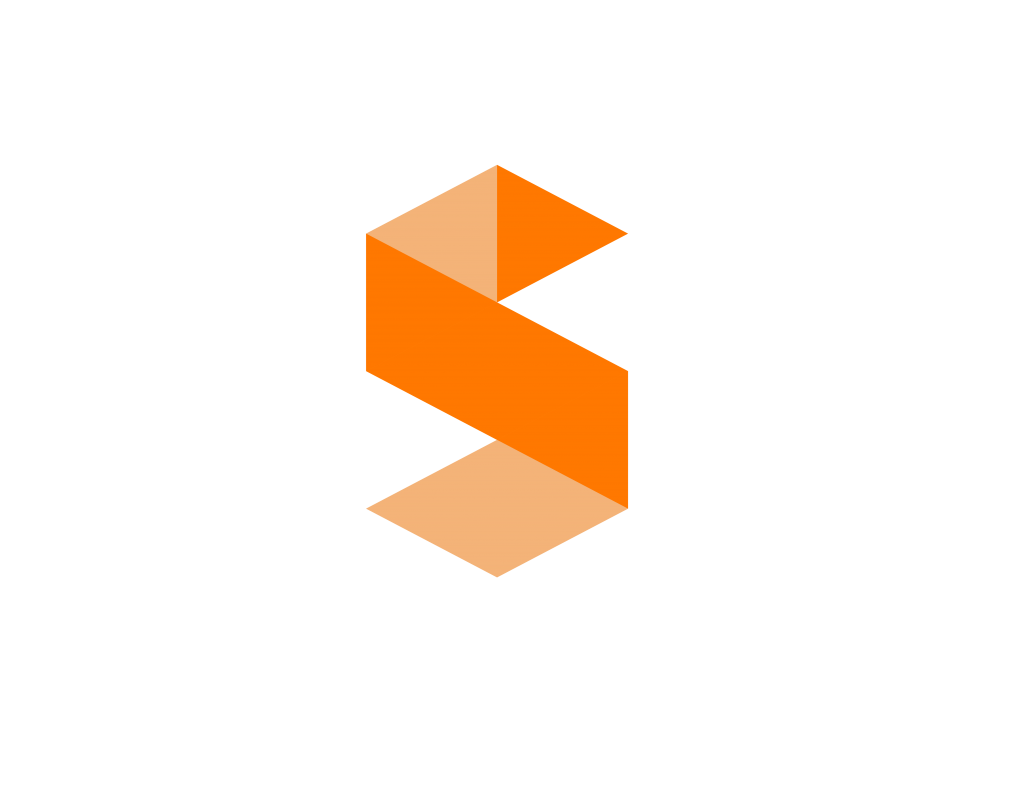بعد انتظار طويل وممل، عادت والدتي إلى المنزل وبيدها ظرف ورقيّ. ارتسمت ابتسامةٌ على وجهها وبدت سعيدة، لكنّها لم تخبرني وإخوتي بما يحويه الظرف. اكتفت بالقول إنّ فيه مفاجأة ستسعدني وإن لم تكن مرتبطةً مباشرة بي. في البداية، ظننت أنّها صورة “إيكو” لطفلٍ آخر ستنجبه وسأتولى أنا تربيته كالعادة، ثمّ خطر لي أنّها ربّما جاءت بشهادة مدرسية لأحد إخوتي، لكن لم يخطر لي أبداً أنّها عائدةٌ من المحكمة التي ستحدّد مسار حياتي، بعد ثلاثين جلسة وثمانية عشر عاماً قضيتها في الانتظار، متقلّباً بين اليأس والأمل.
أبي سوريّ الأصل، كان يؤدّي خدمته العسكرية في لبنان حين تعرّف إلى والدتي، فقررا الزواج والاستقرار في لبنان. لم يثبت والداي زواجهما في أيّ من البلدين، ظنّاً منهما أنّ ذلك سيسهل حصول والدي على الجنسية اللبنانية، كما أخبرهما أحد المحامين. مرّت أعوامٌ وهما في انتظار الجنسيّة، وخلال هذا الوقت الطويل أنجبا ستّة أبناء مكتومي القيد، كنت أكبرهم.
منذ اللحظة الأولى لي في هذا العالم، اتّخذت حياتي مساراً غير اعتياديّ. أنجبتني والدتي من دون تخطيط أو معرفةٍ مسبقة أثناء زيارتها عائلة أبي في سوريا. بعد خروجنا من المستشفى، نقلتني، هي ووالدي، كالبضائع المهرّبة إلى لبنان. فأنا لم أملك أيّ ورقة تعرّف عني، إذ لم يكن باستطاعة أبي تسجيل ولادتي لأنّ زواجه نفسه غير مسجّل. هكذا، عبرت الحدود من دون أن يتنبّه لي أحد. لاحقاً، سأقضي طفولتي على الهامش بلا صخب ولا ضجيج، ولن أثير انتباه أحدٍ أيضاً. بلا صخب أو ضجيج.
كانت طفولتي بائسة وحزينة، لم يخفف من بؤسها سوى أملي بالحصول على الهوية التي حُرمت منها. في منتصف التسعينيات فُتح باب التجنيس أخيراً. هرع والدي لتقديم ملفّه ووكّل محامياً، وبدا شديد التفاؤل حينها. كان ذلك أملنا الوحيد لنحيا حياة طبيعية.