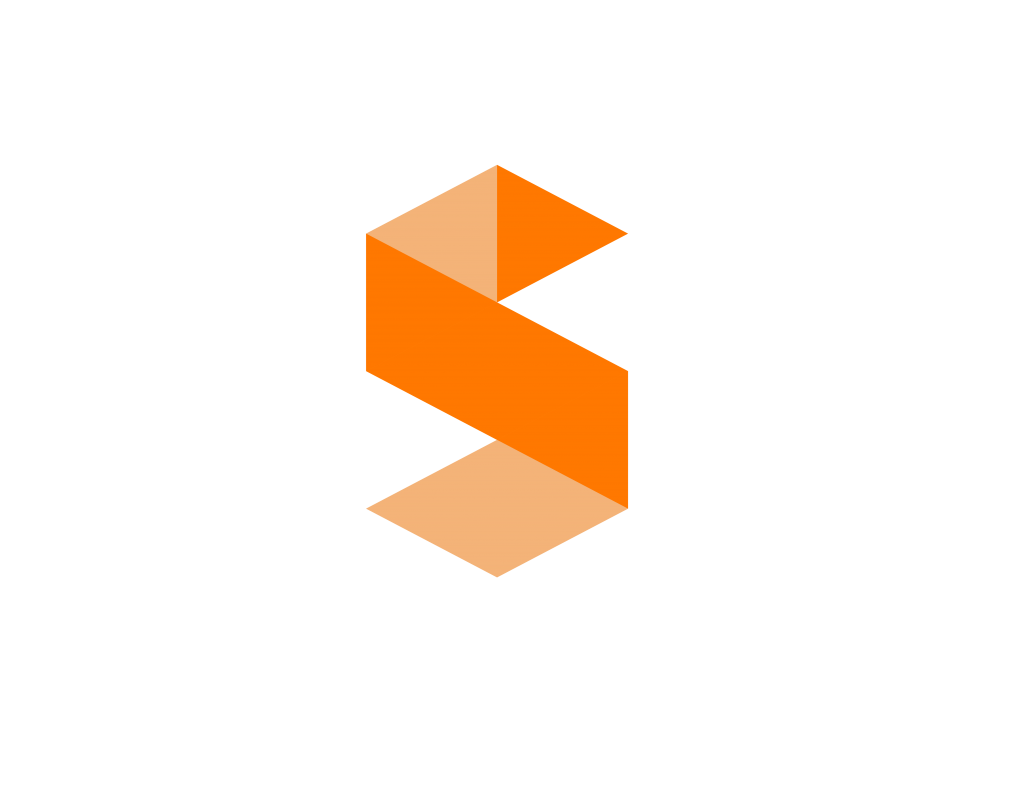10
لم يكن ما حدث في المدرسة في شهر آذار من العام 2009 حدثاً عابراً، بل لحظة انقلبت بعدها حياتي. قالوا إني ارتكبتُ خطئاً فادحاً وقتها، لكنّني الآن أفكّر أنّ ذلك كان من الممكن أن يحدث مع أيّ فتاةٍ أخرى من عمري. لكن، وكالعادة، رُبط الحادث بهويتي الثانية، واعتبر الناس أنّ ذلك متوقعٌ بسبب أمّي الأفريقية “وجيناتها”، وقال بعضهم أنّه من الجيد أنّ خطأي اقتصر على ذلك. كما لو أنّ اقترافي للخطأ محتّم بسبب جيناتي المختلطة.
صُوّر الأمر بطريقةٍ تظهر كلّ بنات الجالية اللبنانيات صالحات وأنا السيئة التي سوّدت وجه أبي.
كنت في الصف التاسع، ولم يكن قد مرّ وقت طويلٌ على ارتدائي الحجاب من دون رغبةٍ منّي في ذلك. كنت أحكمه في حضور أبي وأرخيه في المدرسة، وفي ذهني يدور صراعٌ داخلي بين ما أريد أن أكونه وما أنا عليه في الحقيقة: فتاةٌ مكسورة، يُلحق والدها وصف العاهرة باسمها في كل حين.
دفعتني مراهقتي الصعبة لمرافقة الشبّان في المدرسة. كانت أيّ عبارةٍ من قبيل “أنتِ جميلة” كافيةً لأقع في حب أيّ شاب. كنت بحاجةٍ لأنّ أشعر بأنّني محط اهتمامٍ وإعجابٍ لأعوض حرماني من العطف والحب.
كنّا نبقى في المدرسة لنأخذ حصّة بين الثانية والرابعة. في الوقت المستقطع بينها وبين الصفوف السابقة، كنت أبقي بصحبة رفاقي الصبيان في الصف، حيث نلعب ألعاباً مثل “أمر أو حقيقة”. في البداية انحصرت اللعبة بالاعتراف بأسرارٍ شخصيّة وأفعالٍ محدودة مثل التقبيل، أو بأوامر مثل “المس ثديها”. لم أشعر آنذاك بأنّ هناك مشكلة فيما أفعله، واعتبرت أنّني كنت أستكشف أشياء جديدة. لم أكن وحيدةً في ذلك، إذ كانت كلّ الفتيات يقمن بأفعالٍ مشابهة.
في إحدى المرات بقيت مع ثلاثةٍ من زملائي. كنّا نلعب اللعبة نفسها، وكنت جالسةً على الكرسي وقد أرخيت الحجاب. فجأة، لمحت واحداً منهم يحمل هاتفه وكأنّه يصوّر، عندما سألته عمّا يفعله أجاب بأنّه يتفقّد الرسائل. عندها اقترب زميلٌ آخر منّي، جلس على ركبتيّ وقبّلني على خدّي. دفعته مباشرةً بعيداً عنّي، لكن في تلك اللحظة، اقترب الفتى الثالث وجلس على ركبتيّ بدوره. كان يحتك بجسدي، فطلبت منه التوقّف ودفعته أيضاً.
كانت تلك مجرّد حركات مراهقين، لم أشعر بالإساءة وقتها، دفعتهم بعيداً وضحكنا معاً على الأمر.
بعد نحو نصف ساعة، قال لي الفتى الذي كان يحمل هاتفه: “سوف أربيهّما”، فسألته “لماذا تقول ذلك؟ ما الذي ستفعله؟”. أجابني: “إنهما يعاملانني كخادم لهما، ويرسلانني لأشتري لهما ما يريدانه من الدكّان في أوقات الفراغ. لقد صوّرتهما وسيعاقبان”، ثمّ عرض عليّ الفيديو الذي سجّله. صُدمت وبدأت بالصراخ عليه، “هذه أنا! كيف تجرؤ على فعل ذلك. امحِ الفيديو، أرجوك!”، لكن جوابه زاد صدمتي: “لقد نشرته بالفعل”. انفجر بعدها بالبكاء وهو يعتذر قائلاً أنّه لم يقصد إيذائي بل كان يرغب بمعاقبتهما، وأنّ وجهي ليس واضحاً في الفيديو. علمت في لحظتها أنّ معرفة أهلي بالأمر سيعني دمار حياتي، لكن لم يكن هناك أي شيء أستطيع فعله…
بعد وقتٍ قصير، صار الفيديو متداولاً بين الطلّاب، حتّى أن بعضهم دفع مالاً للحصول عليه. وصل الخبر إلى إدارة المدرسة التي حاولت التستّر على الأمر وإخفاء الحادثة، لكنّ ذلك كان مستحيلاً. انتقل الخبر إلى المدارس الأخرى وعلم أبناء الجالية فيه، ومن ضمنهم هدى التي لم تتوانَ عن إخبار أهلها.
عاقبتنا الإدارة، أنا وزملائي الذين ظهروا في الفيديو، بالاحتجاز في المكتبة أثناء الفرصة، من دون أن يطردوهم خشية “أن تكبر الفضيحة أكثر”. لكن الحادثة كانت قد صارت على ألسنة الجميع، باستثناء أهلي الذين لم يعرفوا بالأمر بعد. عشت في حالةٍ من الرعب والقلق بانتظار اللحظة التي سيصلهم فيها الخبر، وكنت أرتجف خوفاً في كلّ مرّة أتخيّل فيها كيف سينهال والدِي عليّ بالضرب. في تلك الفترة، قمنا بزيارةٍ عائلية إلى منزل هدى. سألتني والدتها عمّا حصل فأخبرتها، ووعدتني أنّها لن تبادر بإخبار زوجة أبي، لكنّها ستقول الحقيقة إنْ سألتها.
مرّ الوقت من دون أن يعرف أهلي بالأمر، حتّى أخي الذي يصغرني بعامين ويذهب معي إلى نفس المدرسة، لم يعرف. كان البعض يقترب منه ويقول: “أنت فتى صالح، أفضل من أختك. ألن تخبر عائلتك بالأمر؟”، لكنّه لم يفهم مقصدهم وحين كان يسألني، كنت أتهرب من الإجابة.
لم أرتح. كنت أعود إلى المنزل وأمضي إلى غرفتي مباشرةً دون تناول الغداء. سألني والدي مراراً إن كنت تعرّضت لمكروه لكنّني تجنّبت الكلام. كان من الضروري أن أخبره، لكنّني كنت خائفةً من ردّ فعله ومن الضرب الذي سأتعرّض له. تخيّلته يدفنّني حيّة، فصمتت.
كان أبناء الجالية يتناقلون الخبر، ويهاتف بعضهم أهلي في محاولةٍ لمعرفة إن كانوا قد علموا بالأمر. أخيراً، وصل الخبر إلى زوجة أبي أثناء زيارةٍ لإحدى صديقاتها. عندما جاء ليقلّها بدأت بالصراخ: “فضحتنا ابنتك! لقد صوّروها، أنظر لفعلتها”.
جُنّ أبي لما علمه. حين وصلا إلى المنزل، كنت أنا جالسةً مع أخي مرتديةً ثوب الصلاة. اقترب صوت خطوات أبي، وحاول أن يفتح الباب، لكنّه كان مقفلاً، فبدأ بالضرب عليه بقوّة. فهمت مباشرةً أنّه لا بدّ قد عرف وأحسست بأنّ حياتي قد انتهت.
11
لم أجرؤ على فتح الباب. كنت أقف مرعوبةً، فيما طرقات أبي عليه تزداد قوةً مع مرور الدقائق. حين استجمعت نفسي أخيراً وفتحت الباب، انهال والدي عليّ بالضرب، فيما زوجته تصرخ من خلفه: “ماذا فعلتِ يا شرموطة؟ لقد وضعتِ رأسنا في التراب!”. وضعت أختي الصغيرة على السرير وجاءت بحزام أبي وراحت تضربني به، فيما تدوس بقدميها على جسدي وترفسه. ثمّ صرخ والدي بها قائلاً: “أمسكي بها جيّدًا”، وبدأ بتوجيه اللكمات إلى وجهي.
صحت به: “أرجوك توّقف يا أبي. الأمر غير صحيح! لم يحدث شيء”، فأجابني: “كاذبة! ألستِ أنتِ الفتاة التي في الفيديو؟”، وقبل أن أجيب تابع صراخه قائلاً: “سأقصّ شعرك. سأذبحك”.
ركض إلى المطبخ بحثاً عن سكين، من دون أن يهتم بصوت جرس الباب يُقرع في تلك الأثناء. كانت صديقة زوجته التي أخبرتهما سرّي، مع ابنها الذي خلع الباب. كانت تشعر بالذنب وخافت من ردّة فعل أبي. دخلت مسرعةً وجرّبت أن تقف حاجزاً بيني وبينهما من دون جدوى. حمل أبي كرسيّاً ورماه نحوي، لكنّ المرأة اندفعت في محاولةٍ لردّه فأصاب كتفها. في تلك اللحظة سَكَنَ أبي واعتذر من المرأة التي رجته أن يتوقّف عن ضربي. ارتمى هو على الكرسي، فيما واصلت زوجته الصراخ عليّ: “لقد جلبت الفضيحة لنا والعار للجالية”. كنت أشعر بألمٍ شديد في كل أنحاء جسدي، فوضعت رأسي في حضن المرأة.
فجأةً، انتفض أبي من مكانه وشدّني من شعري قائلاً: “سنذهب إلى الطبيب. أريد أن أعلم إن كنتِ عذراءَ أم لا”.
حاولت ردعه وأخبرته أنّني لم أفعل ما يجلب العار، لكنّه لم يصدّقني. حاولت أن أفهمه أنّني لم أقم بأيّ علاقةٍ جنسية، لكنّه لم يأبه بكلامي، وراح صراخه يرتفع. قبل أن ننزل من السيارة قال لي: “إن كنتِ غير عذراء فمن الأفضل لكِ أن ترمي بنفسك الآن من على الشرفة”.
وصلت إلى المستشفى بثيابٍ ملطخةٍ بالدماء التي كانت تسيل من شفتيّ ووجهي المتورّم. دخلنا عيادة الطبيب فراح الناس يسألوننا إن كنت قد تعرّضت للاغتصاب، نفى أبي ذلك بحزم فلم يقل أحدٌ بعد ذلك شيئاً.
عندما جاء دورنا، أراد أبي الدخول معنا إلى الغرفة ليتأكّد من أنّي عذراء، لكن صديقة زوجته منعته. دخلت الامرأتان معي، وبعد الفحص قال لهما الطبيب أنّني بالفعل عذراء. عندما أبلغتا والدي بذلك قال لي: “احمدي الله أنّك عذراء، وإلّا كنت سأدفنك بيديّ هاتين”.
في طريق العودة التفت صوبي مرّة أخرى وقال: “سأقلّ الصديقة إلى منزلها ومن ثمّ سنعود إلى المنزل لأؤدّبكِ”. عندها تدخّلت صديقة خالتي ورفضت أن أعود إلى المنزل وأبلغت أبي أنّني سأذهب معها إلى منزلها، فأجابها: “خذيها. لا أريد رؤية وجهها”.
بقيت عند المرأة أسبوعاً قبل أن تجيء خالتي لزيارتي. بعد ذلك بوقت قصير، أبلغني أبي أنّه سيرجعني إلى المنزل لكن بشروطٍ جديدة: “ستكونين سيريلانكيّة. ستتركين المدرسة، ستقومين بتربية أختك الصغيرة، وعندما تكبر أختك ستعرف بما قمتِ به وستكرهك لأنّكِ جلبت العار لها. سأطرد الخدم وستبقين أنت خادمتنا. لن تناديني بأبي بعد الآن بل “مستر”، ولن تنادي خالتك بماما بل “مدام”. أنتِ الآن خادمة”.
في طريق العودة، توقف أمام “سوبر ماركت” وطلب منّي أن أنزل معه. كانت عيني ما تزال متورّمة وكذلك شفتي التي كانت مشقوقة، فرفضت النزول. ضربني وأجبرني على النزول قائلاً: “تشعرين بالخجل من وجهك لكنّك لا تخجلين بفعلتك”. في الداخل، مشيت خلفه وأنا أجرّ أختي الصغيرة في عربتها. كان الناس في تلك المرحلة قد بدأوا بتأليف أخبارٍ عنّي، مدّعين بأنّ هناك فيديوهات أخرى تدينني، وبأنّني أعمل في الدعارة. لذا، أراد والدي أن يُبرهن لأبناء الجالية بأنّه أدّبني، أراد لهم أن يروني مضروبة ومتورّمة. انتقل بي من سوبرماركت إلى أخرى ليتأكد من معرفة الجميع، وصادفنا زملاء من المدرسة وأفارقة وحتّى بعض الأجانب، وكان الجميع يتهامسون قائلين: “هذه هي اللبنانية التي صوّروها”.
راح بعضهم ينادي بعضاً، وفجأةً صار جسدي فرجةً لهم كدليلٍ على تأديب الأب الصالح لابنته المخطئة.
صحيحٌ أنّني كنتُ خجلةً من الفيديو، لكنّني لم أستوعب رغبة أبي المرضيّة بالتشهير بي أمام الناس، ولم أعرف كيف أطاعه قلبه لاحقاً على أخذي من منزلٍ إلى آخر في زياراتهم وزوجته ليعرض صنيعه أمام كل من يعرفهم من اللبنانيين. كان يجبرني على الذهاب معهم، ثم يطلب من أهل البيت الذي نزوره أن يُجلسوني مع الخدم أو أن يرموني في الخارج بجانب الكلاب. أما عندما كنّا نستقبل الناس في بيوتنا، فكان يجبرني على تقديم الضيافة ليروا هيئتي. فوق ذلك، هاتف جميع إخوته في أفريقيا ولبنان ليخبرهم بما جرى وليفضحني أمامهم.
كان أبي شخصاً سريع الغضب، لذا كان بعض الناس ينقلون إليه أخباراً مزيّفةً عنّي بغرض إيذاءه، ويقولون له أشياء من قبيل: “لقد قلنا لك أنّها أفريقية عاهرة، لكنّك لم تصدّقنا…”، أو “لقد حجّبتها وحاولتَ أن تجعلها محترمة، لكن العهر يجري في دماء هؤلاء الأفارقة”.
ارتدّ ذلك عليّ بشكل مرعب، إذ دفعته عبارات كهذه إلى المواظبة على ضربي يومياً وشتمي طوال الوقت. يقول: “كل تفكيركِ في الجنس، همّك بين فخذيك. تريدين أن تكوني شرموطة، عاهرة، تماماً كأمّك. أمّك كانت عاهرة”.
12
على الرغم من كلّ ما مررت به، إلّا أنّ حرماني من المدرسة كان أسوأ ما تعرّضت له على الإطلاق.
في ظهيرة أحد الأيّام نادتني خالتي وقالت لي: “سنحرق كل كتبك وكلّ ما يتعلّق بكِ. لن تعودي إلى المدرسة بعد أن قمتِ بفعلتك”.
أشعلتُ الموقد بنفسي، ثمّ أحضرتُ كتبي من الغرفة ووقفت أمام النّار على الشرفة ورميتُ كتبي فيها. راحت خالتي تنزع الصور المعلّقة على جدران غرفتي والميداليّات التي حصدتها وشهاداتي وصوري وترميها في النار. لا أملك اليومَ إلّا القليل من صور الطفولة والمراهقة، إذ حُرق معظمها آنذاك.
كان الجيران يتفرّجون علينا، فيما هي ترمي ما تبقّى من أغراضي في النار، ودموعي تنساب على وجنتيّ في نوبةٍ من البكاء المرير.
لزمت البيت، حيث عملت كخادمة. كان ممنوعاً عليّ أن أقضي أيّ لحظةٍ بمفردي. يوقظني والدي في الصباح الباكر قبل مغادرته إلى العمل، فأبدأ بالقيام بالأعمال المنزليّة والاعتناء بأختي الصغيرة. حتّى عند دخولي إلى الحمام كان ممنوعاً عليّ أن أقفل الباب، وإن أطلت في الداخل يطرق والدي الباب عليّ مستفسراً عن السبب.
في الوقت نفسه، كان وزوجته يخشيان منّي، إذ كان يرفض أن يأخذ الشاي أو القهوة من يدي خشية أن أكون قد سمّمت فنجانه، وكذلك خالتي التي كانت تخاف على أختي مني، فتأخذها منّي وتقفل عليها باب الغرفة، كلما أرادت الاستحمام.
لم أكن ألتقي بأحد من معارفي، باستثناء هدى التي جاءت مرّة لزيارتي، أو لإهانتي على الأرجح، بعد أن أشاعت عنّي بين الشبّان اللبنانيين أنّي لست عذراء، رغم معرفتها بالحقيقة.
عانيت في تلك الفترة من الاكتئاب من دون أن أعي ذلك. كنت أرتجف طوال الوقت وذهني مشتت ومشوّش.
في إحدى المرات، حين كنت أساعد خالتي في تحضير الطعام أوقعت صحناً من يدي، فراحت تصرخ عليّ. تردّت حالتها النفسية إثر الحادث فصارت تزور معالجاً نفسيّاً، أمّا أنا فلم يلقِ أحدٌ بالاً إلى ما كنتُ أمرّ به.
على الرغم من كلّ شيء، بقي أخي إلى جانبي. كانت صديقاتي من غير اللبنانيات متعاطفات معي، فكنّ يرسلن إليّ من خلاله رسائل الدعم التي أقرأها سرّاً في الحمام. لكن، وبعد فترة، رأى أبي إحدى صديقاتي تتكلّم مع أخي بعد الدوام فهدّده ومنعه من الحديث معهنّ. رضخ أخي لأوامره، لكنّه استمر بمساعدتي في الدروس. بسبب نظام مدرستنا التعليمي، كنّا نتشارك نفس الكتب في بعض المواد، لذا كان يتركها لي حتّى أتمكّن من متابعة الدروس. لم يعجب ذلك والدي بالطبع، فكان يقول كلّما رآني أدرس: “الآن استيقظ فيك حبّ الدراسة بعد أن كنتِ عاهرةً في المدرسة؟”.
واصل أبي ممارسته العنف عليّ، ووصل إلى ذروته خلال زيارة زوجته إلى لبنان، حيث بقيت مع شقيقي برفقته في سيراليون. في يومٍ من الأيّام انفجر غضبه عليّ لسببٍ لا أذكره، وراح يضربني أمام شقيقي.
فجأةً توقف عن ضربي. نظر إليّ وأمرني: “اخلعي ثيابك”. صدمتني كلماته. حدّقت في عينيه مستفهمة، لكنّه صرخ بي مجدّداً: “اخلعي ثيابك”، فخلعتها.
بقيت واقفةً في ثيابي الداخلية أحاول عبثاً أن أخفي جسدي بيديّ. عندها أتاني الأمر الثاني: “افتحي الباب، انزلي على الدرج، واخرجي من المنزل”.
تجمّدت في مكاني، فارتفع صوته بالصراخ والشتائم.
مشيت صوب باب البيت وفتحته، ثم نظرت إلى والدي مرّة أخيراً لكنّه بدا مصمّماً. سرت إلى الخارج ونزلت بضع درجات، عندها انفجر بالضحك وصرخ بي: “ارجعي، ارجعي. أهذا ما ترغبين به؟”.
لم أفهم يومها ما الذي دفعه لفعل ذلك، وما زلت حتّى الآن غير قادرةٍ على تحديد ما إذا كان ذلك تحرّشاً أو اعتداءً.
على كلّ حال، دفعت ثمن ما جرى في المدرسة لسنواتٍ طويلةٍ لاحقة. رافقني ذلك كوصمةِ عارٍ لا مفرّ منها. ولم يتوقّف والدي عن إهانتي وشتمي وتعييري بدمي الأفريقي سوى قبل عامين فقط، وإن لم يتخلّ عن وصفي بـ”الدنكورة” من حينٍ إلى آخر.