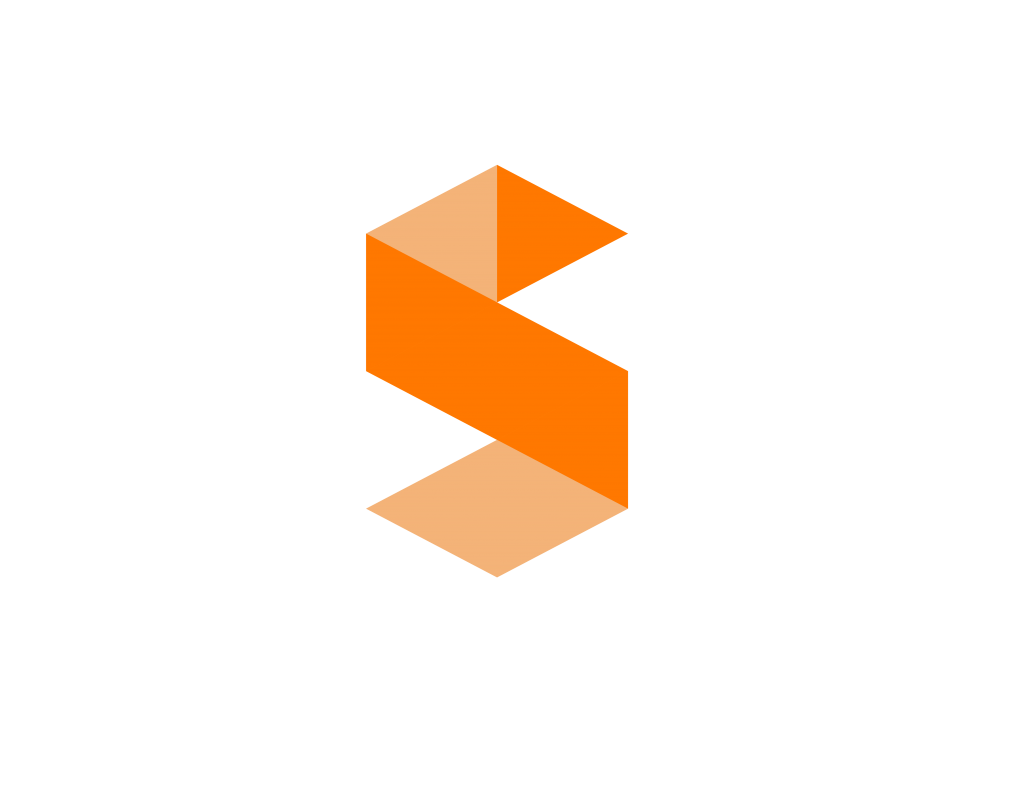
منصة إعلامية تهدف إلى تعزيز استخدام مهارات السرد القصصي الرقمي في الانتاج الصحافي. القصص المنشورة في المنصة من انتاج صحافيين/ات وصانعي/ات محتوى شباب من جميع المناطق اللبنانية، تم تدريبهم/ن وتوجيههم/ن من قبل فريق StoryLeb.
يندرج StoryLeb ضمن مشروع Shabab Live وينفذ بالشراكة مع أكاديمية دويتشه فيله (DW Akademie) ومنظّمتي “الجنى” و”الخط”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودعم من وزارة الخارجية الألمانية.
محرر تنفيذي: إبراهيم شرارة
وسائط متعددة: فرات شهال الركابي
تحرير: رضا حريري، صباح جلول
تطوير تقني: جعفر شرارة، روان الحوري ابو النصر
تصميم: إبراهيم شرارة
الترجمة إلى الإنكليزية: صباح جلول، روان المقداد
انضم/ي إلينا
تم إطلاق هذه المنصة بمساعدة مالية من المفوضية الأوروبية في إطار مشروع شباب لايف (Shabab Live)، وهو مشروع مشترك بين “أكاديمية دويتشه فيله” و”مركز الموارد العربي للفنون الشعبية” و”الخط”. محتوى هذه المنصة هو مسؤولية StoryLeb وحده ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره يعكس موقف المفوضية الأوروبية أو شركاء المشروع.




